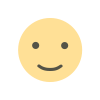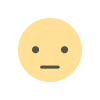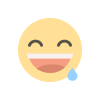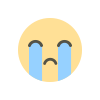العراق: ماذا بعد كسر أحد «أضلاع» الرئاسات الثلاث؟

نهاية أكتوبر الماضي، كان قد مضى عام واحد على مباشرة حكومة رئيس الوزراء السوداني في سدة رئاسة الوزراء، وخلال أكثر من ثلاثة أرباع السنة بدا أن كل شيء يسير بهدوء واستقرار غير معهود في سياق السياسة العراقية المحتدم منذ عقود طويلة، فالسوداني المعروف بالهدوء وعدم الميل إلى الصدام مع الشخصيات والكتل السياسية، سعى ومن ورائه حلفاؤه وداعموه في قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، إلى استثمار فرصة الهدوء السياسي والأمني النادرة للتركيز على ملف الخدمات المتهالكة، على أمل أن يسجل نقاطاً مهمة في «مرمى الفشل» المزمن الذي عانت منه الدولة العراقية خلال العقدين الأخيرين؛ نقاطاً تكرّس وجوده زعيماً شيعياً بين الكبار يمكن أن تؤهله للعب دور حاسم في الانتخابات البرلمانية العامة عام 2024. وصب التوافق بين القوى السياسية الشيعية والكردية والسنية على تنصيبه ضمن ما يعرف بتحالف «إدارة الدولة» في صالح عمل السوداني في ظروف مناسبة لم يسبق أن كانت مطروحة لمعظم رؤساء الوزراء الذين سبقوه.
ومع كل ذلك، ومثلما تبدو أيام الهدوء والاستقرار طارئة غالباً في بلد مضطرب مثل العراق، يبدو التنبؤ بمآلات البلاد في مرحلة ما بعد الإطاحة برئيس البرلمان محمد الحلبوسي بحكم قضائي، مهمة ليست باليسيرة.
لكن المؤكد أنها هشمت وبقوة حالة الاستقرار النسبي التي حظيت بها حكومة السوداني خلال الأشهر الماضية، وبخروج الحلبوسي من السلطة، كسر بذلك أحد الاضلاع الثلاثة للحكومة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) التي تقود حالة الحكم التوافقي في العراق. وما إلى ذلك من تعقيد يعيد مشهد التوافقات السياسية إلى نقطة الصفر التي انطلقت منها العام الماضي، حين تحالف «الإطار التنسيقي الشيعي» مع القوى الكردية وتحالف «تقدم» الذي يقوده الحلبوسي لتشكيل حكومة السوداني.
وقد ظهرت ملامح هذا التعقيد والانقسام السياسي الحاد اللذين يهددان حكومة السوداني بعد لحظات من صدور حكم المحكمة الاتحادية بإقالة الحلبوسي، على خلفية قضية تزوير ضد أحد النواب السابقين، حين أعلن وزراء تحالف «تقدم» الثلاثة في الحكومة (التخطيط، الصناعة والمعادن، الثقافة)، وكذلك معظم نواب الكتلة، تعليق عملهم في البرلمان.
وإذا ما واصل وزراء ونواب الحلبوسي استقالاتهم، فإن البرلمان والحكومة سيحتاجان إلى «صفقة توافق» جديدة بين الكتل والأحزاب النافذة لإعادة تقسيم المناصب، وإذا ما نجحت أيضاً الكتل في ذلك من خلال استقطاب خصوم الحلبوسي من الجماعات السياسية السنية المنافسة له، وخاصة في تحالف «عزم» الذي يقوده النائب مثنى السامرائي في ملء شواغر الوزراء والنواب، فإن تعقيداً آخر سيظهر ويتعلق بحالة الاحتقان التي ستعم المحافظات السنية التي تؤيد الحلبوسي، وما قد ينجم عن ذلك من اضطرابات تعيد إلى الأذهان اضطرابات «داعش» قبل وبعد عام 2014، التي أعقبت إقصاء نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي عام 2011، ووزير المالية رافع العيساوي الأسبق عام 2012، وكلاهما ينتمي إلى المكون السني. وقد أشار الحلبوسي بوضوح إلى ذلك بعد سماعه نبأ إلغاء عضويته ورفعه لجلسة البرلمان حين قال: «جئنا من مجتمع كان يرفض العملية السياسية لغاية 2014، والمعارضة بأشكالها المختلفة أدت إلى سقوط ثلث العراق».
ولا يرتبط الزلزال السياسي الجديد، بحسب كثير من المراقبين، بطبيعة التوافقات السياسية التي أفرزتها انتخابات عام 2020 التي جاءت بالحلبوسي رئيساً للبرلمان لدورة ثانية، ولا بغضب وامتعاض الاتجاهات السنية الموالية للحلبوسي فحسب، إنما بطبيعة قرارات المحكمة الاتحادية وأهدافها وحدود صلاحياتها والجهات المؤثرة فيها، وسبق لزعماء «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أن اتهموها بالتبعية والانحياز السياسي لأطراف محددة.
ويبدو أن الحلبوسي يسير في اتجاه التشكيك والطعن في صحة قرار إقصائه، حين قال في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن ثمة شروطاً لإنهاء عضويته رئيساً لمجلس النواب، وهي إما «الوفاة وإما الاستقالة وإما تبوؤ منصب تنفيذي وإما بوجود حكم قضائي جنائي أو مرض عضال».
وذكر أن «المحكمة الاتحادية لم تلتزم بالشروط المذكورة كلها». وأضاف أن «واجبات المحكمة الاتحادية الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، والفصل بين النزاعات القانونية، والفصل في المنازعات بين الأقاليم والمحافظات».
وإذا ما نجح الحلبوسي في خوض معركته مع المحكمة الاتحادية التي توصف قراراتها بالقطعية وغير القابلة للنقض، فإن البلاد أمام سلسلة طويلة من المعارك القضائية والسياسية التي ستنعكس سلباً على حالة الهدوء والاستقرار النسبي، وقد تطيح بموعد الانتخابات المحلية المقرر في 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، خاصة مع دعوة مقتدى الصدر أتباعه لمقاطعتها والانسحاب المتوقع لتحالف الحلبوسي.