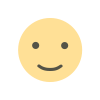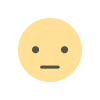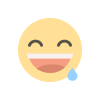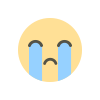عن رفيق الحريري الحاضر رغم غيابه
بقلم د. مصطفى علوش - خاص مراسل نيوز

«كُلَّ يَومٍ لَكَ اِحتِمالٌ جَديدُ وَمَسيرٌ لِلمَجدِ فيهِ مُقامُ
وَإِذا كانَتِ النفوس كِبارًا تَعِبَت في مُرادِها الأَجسامُ» - المتنبي
ليس في نيتي أن أُدخل رفيق الحريري في مجال الندبيات الموسمية وجلسات العزاء التي تستذكر روايات، لا تهدف في أساسها مديح الشهيد فقط، بل لتحوّل الرواية إلى وسيلة لتسويغ العداء ضدّ فئة أو جماعة وتحلّل دمها، وتخلق الأسباب لتقصّد ظلمها، بناءً على حكايات غير مسندة، إلّا بالتقليد الشفوي المتناقل بين الأجيال، أحيانًا لعشرات القرون. لكنني استذكره دائما عندما ألتقي بشبان أصبحوا يستسهلون الحديث عن الشأن العام، وهذا بالطبع يبشّر بالخير بهمّة الشباب. لكن الإشكال يبرز عند اختصار هؤلاء كل الأزمات ببعض الشعارات، ولكن من دون معرفة المضامين، إلّا ما هو مرتبط بما سمعوه من هنا وهناك، عن طريق التقليد الكلامي، الذي يعفي السامع من عناء البحث والتدقيق في المصادر ومدى صحتها. الإشكال هو أنّ السائد من ثرثرة بين الناس يصبح بديهيًا، ومع الوقت يمسي البديهي حقيقة شعبية، ويصبح من المستحيل تحليل أصلها، إلّا لمن هم من ذوي الألباب، الذين يفضّلون عناء البحث والتدقيق لاستنتاج الحقائق، بدل كلام الناس.
كان الأسى، حسب معرفتي، يغمر قلب رفيق الحريري عندما كان يُرغم على معالجة صغائر الأمور المتعلقة بزواريب السياسة اللبنانية على مدى ربع قرن من حياته في الشأن العام. فعلى الرغم من جسامة المهمّات الملقاة على عاتقه، فإنّه كان يعلم بأنّ حتى أتفه الأمور كان فيها القدرة الكامنة على إعاقة حتى أهم المشاريع ذات الأبعاد الوطنية والقومية وحتى العالمية، في ظل الوقائع المحلية والإقليمية الشوهاء. لقد كان كل جسر يُبنى أو كل مستشفى أو جامعة، لا يمرّ من دون أن يحظى برضى جملة من المتناقضات غير السوية، لو كنا في دولة سوية. لذلك فقد كان عليه، وبشكل شخصي في كثير من الأحيان، التعامل مع مسائل قد تبدأ في حَرَدِ ضابط مخابرات، إلى حساسيّة زعيم محلي، إلى استكبار مرجع طائفي، إلى ما هنالك من تفاصيل لا مكان لها في عالم السياسة، وإن كانت في لبنان تُسمّى سياسة.
لقد أُجبر على التعامل مع هذه التوافه ليحمي الرؤيا المستقبلية والمهمات الكبرى الملقاة على عاتقه. هذه المهمات هي التي شكّلت البعد الآخر لرفيق الحريري.
كانت بدايات تدخُّله في الشأن العام خلال المؤسسات التي علّمت ومدّت يد المساعدة للبنانيين في كل المجالات. هذه الأعمال، وإن كانت ذات بُعدٍ إنساني مباشر، فقد كان تأثيرها على المستوى السياسي شديد الأهمية. فمن ناحية، تمكن من انتشال الآلاف من الشباب من أتون اليأس والموت، ومن ناحية أخرى أمّن للبنان احتياطيًا نخبويًا، ظهرت آثاره بقوة بعد دخول لبنان في عصر اتفاق الطائف، الذي ساهم هو شخصيًا في تسويقه وإعداده، بعد أن أُحبطت محاولاته الأولى والمستمرة منذ العام 1983.
أما المهمة الثانية، فقد كانت قيادته تحدّي السلام المحتمل الذي كانت بوادره واضحة من خلال مؤتمر مدريد. لقد كان التحدّي هو كيفية إعداد لبنان ليكون رأس الحربة العربية في مواجهة مشاريع الهيمنة الإقتصادية والثقافية للكيان الصهيوني.
دخل يومها رفيق الحريري في سباق محموم، تمثّل في ورشة الإعمار والتحديث التي أطلقها منذ العام 1992. وضع نصب عينيه بناء اقتصاد متين ومتنامٍ في لبنان ليكون نواة المشروع الإقتصادي العربي الذي سوف تستفيد منه سورية بشكل مباشر، من خلال شراكة حقيقية كان يمكن أن تُدخلها، في عملية إنماءٍ لا سابق لها، نظرًا للمميزات التفاضلية المتعددة للبنان وسورية معًا، لو تكاملا دون هيمنة لطرف على آخر ودون استغلال أحدهما للآخر. ولكن، عملية السلام انهارت في أواسط التسعينات، وتوقف معها انفتاح النظام السوري، المتعثر أصلًا، نحو الحداثة ونحو التوجّهات الديموقراطية والتي هي أساس أي نمو إقتصادي. أدّى ذلك إلى عودة سيطرة التوجّهات الأمنية والمخابراتية على خيارات السلطة في سورية، مما أنتج عمليًا ما سُمّي بالنظام الأمني اللبناني- السوري، الذي تولّى قيادته الجنرال اميل لحود من خلال رئاسة الجمهورية. تمثل ذلك في عملية إقصاء الحريري عن الحكم سنة 1998 كمؤشر إضافي لتراجع احتمالات السلام في الشرق الأوسط.
لكن، بدأت تلوح في الأفق الدولي والإقليمي بوادر أزمة جديدة، تمثلت في بروز نوع جديد من التهديدات الإرهابية للنظام العالمي، من خلال المجموعات الأصولية السنيّة، والتي أصبح تنظيم القاعدة الممثل الأبرز لها. كانت الإدارة الأمريكية تعتبر الأصوليات الشيعية المتمثلة بالخمينية، الخطر الأكبر عليها على مدى عقدين سابقين، بعد سلسلة دموية من العمليات الإرهابية الكبرى، والتي كان لبنان المسرح الأهم لها. لكن عمليتي كينيا المشهورتين، والتي طالت إحداها السفارة الأمريكية، دفعتا الإدارة الأمريكية إلى إعادة ترتيب أولوياتها، بحيث أصبحت الأصوليات السنّية تشكّل التهديد الإرهابي الأول للإدارة الأمريكية.
لم يتوقف الأمر عند ذلك الحدّ، فبعد حلول الإيديولوجية الجديدة للرئيس بوش في موقع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد عملية 11 /9 الكارثية، أصبح الدين الإسلامي وأصول تعاليمه العدو رقم واحد للإدارة الأمريكية. تمثل ذلك في الضغوطات الكبرى التي مورست على الدول السنّية لتعديل برامجها التعليمية. في الوقت ذاته، برزت بوادر انفتاح تجاه القوى الشيعية، أنتج تعاونًا بين الولايات المتحدة وإيران خلال الحملة على أفغانستان، ومن ثم العراق. كما أنّ الإدارة الأمريكية استثنت المنظمات الشيعية الواسعة الإنتشار، ومن ضمنها «حزب الله»، من مسألة تقييد النشاطات وتجميد الأرصدة، في حين تمّ خنق كل المؤسسات السنيّة، وحتى الإنسانية منها.
برزت عندها شائعات عن مشروع «هلال شيعي» يقسِّم العالم الإسلامي وينقل دائرة الصراع إلى قلبه لإضعافه ولتسهيل السيطرة عليه. في هذا الوقت شهدنا الرئيس الحريري في حركة مكوكية بين عواصم القرار، في محاولة لإبراز خطورة هذا المشروع على الأمن والسلم العالميين. وقد كان يحاول طرح مشاريع حوار وتفاهم بين قوى الإنفتاح الإسلامية وبين الغرب، بدل مشاريع المواجهة المفتوحة التي أطلق عليها لقب صراع الحضارات. لقد لاحظنا في تلك الفترة التمايز الذي أبدته القوى الاوروبية، وفي طليعتها فرنسا، عن الموقف الانغلوسكسوني بالنسبة لاحتلال العراق. لم يكن الإهتمام الدولي الاستثنائي بقضية الاغتيال إلّا اعترافًا بالدور المتقدّم الذي لعبه في حياته كصانع سلام وداعية تفاهم، في الوقت الذي لا ترفع فيه الرايات إلّا لصانعي الحروب وأبطالها.
لقد انطلق رفيق الحريري من قناعة راسخة بأنّ مصالح الناس واستقرارهم هي الأولوية الكبرى، وعلى الرغم من أنّه كان يعلم أنّ حياته مهدّدة كل الوقت، فإنّه لم يتصور يومًا أنّ وقاحة المجرمين سوف تصل إلى درجة اغتياله بالطريقة التي حصلت فيها. وفي كل يوم، وبعد الدمار الذي لحق بالمنطقة وبلبنان خاصة، على مدى 19 سنة من اغتياله، يجب أن يخرج شبابنا الثائر من بديهيات الشعارات التي تحصر كل مصائبنا بالسياسات الحريرية، للبحث في حقيقة الأمور بدل التمسك السهل بالقشور.
سمعت الكثير من الانتقادات للسياسات الحريرية، وللأمانة بعضها محق، ولن ألجأ هنا إلى مقولة «ما خلونا»، فقد كان بالإمكان كسر الحلقة المفرغة من التسويات بشكل مبكر، او الاعتكاف والخروج من الدوامة، وقد ناقشنا الأمر في أيام رفيق الحريري. لكن، كما أصبح معلومًا، فعندما قرّر كسر الحلقة المفرغة اتُخذ قرار الإعدام.
قد يكون للسياسات الحريرية الكثير من الأخطاء، ولكن أن تؤخذ تلك الأمور من دون سياقها التاريخي الواقعي، وبالتالي استسهال رمي الأمور عليها، فهذا يعني بالتأكيد الاستمرار بسياسات النعامة ودفن الرؤوس في الرمل.