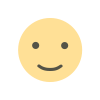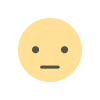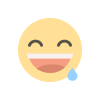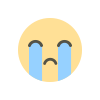حين تصبح الذاكرة وقودًا للسلطة: من بطولات الحرب إلى أزمات الحاضر
بقلم الباحث و الكاتب السياسي عبد الحميد عجم

في الذكرى الخمسين للحرب الأهلية اللبنانية، لا نجد أنفسنا أمام لحظة تأمل أو مراجعة، بل في قلب سباق حزبي محتدم على ملكية الذاكرة. تُستدعى الحرب من جديد، لا كدرس للتعلم، بل كذخيرة انتخابية تُعيد إنتاج الانقسامات ذاتها التي أنهكت الوطن ذات يوم. بدل أن تكون الذكرى مناسبة للاتعاظ، تحوّلت إلى مسرح لإعادة صياغة الروايات، واستحضار الشعارات، واستثمار الشهداء.
السؤال الصعب اليوم: من الذي يملك حق استعادة ذاكرة الحرب؟ ومن يملك حق الصمت عنها؟
في بلدٍ مثل لبنان، لا تُكتب الذاكرة في كتب التاريخ، بل تُنقش في الأحياء، في وجوه الناجين، في صمت الأهالي، وفي المناطق المختلطة التي تحوّلت يومًا إلى خطوط تماس. لم تكن الحرب الأهلية ساحة مواجهة مع العدو، بل ساحة انهيار للثقة. الجار هاجم جاره، والطائفة حاصرت الأخرى. لا مجال للفخر في ذلك، بل للحزن العميق.
المواطن الذي عاش تلك السنوات لا يرى في استعادة الحرب بطولة، بل مأساة. والذين قضوا لم يكونوا دائمًا "أبطالًا" بالمفهوم الحزبي، بل في أحيان كثيرة، مجرد أبرياء وُجدوا في المكان الخطأ.
من المقاومة إلى شعار الطائفة
"المقاومة" مفهوم كبير، لكنّه في لبنان لم يَسلَم من التسييس. تحوّلت من شعار مسيحي في السبعينات إلى هوية سياسية حصرية لفريق طائفي بعد عام 2000. لم تعد المقاومة مفهوماً وطنياً جامعاً، بل سلاحاً خطابياً يُستدعى لتبرير الهيمنة أو تثبيت الزعامة.
هذا التحول لم يحدث عبثًا، بل في سياق تقاطع بين غياب الدولة، وبقاء السلاح خارجها، وبين رغبة بعض القوى في احتكار "التاريخ والمستقبل" معًا.
اتفاق الطائف: فرصة لم تكتمل
اتفاق الطائف لم يكن عدوًا لو تحققت نواياه بالكامل. بالعكس، شكّل إطارًا عقلانيًا لإعادة بناء الدولة وإنهاء الاحتراب. لكن المشكلة لم تكن في النصوص، بل في التطبيق. استُغلّ الطائف من قبل بعض القوى للحفاظ على مكاسب الحرب، بدل بناء مؤسسات قادرة على ضمان السلم الأهلي والعدالة.
وحتى اليوم، لا يزال كثيرون يحمّلون الطائف مسؤولية الإخفاق، بينما الخلل الحقيقي يكمن في غياب الإرادة السياسية لتطبيقه كما هو.
رغم مرور عقود على الحرب، لم تتحقق عدالة انتقالية حقيقية. العفو العام طمس الجرائم الكبرى، ولم تُجرَ أي محاسبة فعلية للذين فجّروا خطوط النار وفتحوا أبواب الجحيم.
الضحايا لم يُنصفوا. وعائلات المخطوفين والمفقودين لا تزال تنتظر إجابات. والأسوأ، أن معظم صُنّاع الحرب ما زالوا حاضرين في الحياة السياسية، بأسمائهم أو بورثتهم.
السؤال الموجع الذي يُطرَح اليوم في كل بيت: هل نحكم أنفسنا كدولة، أم لا نزال نُدار كطوائف؟ معظم الوجوه السياسية لم تتغير منذ ما بعد الحرب، وبعضهم لا يزال يستدعي خطابات تلك المرحلة وكأنّ شيئاً لم يتغير.
الذاكرة الجماعية تُدار اليوم كأرشيف خاص، تُفتح صفحاته فقط حين يحتاج السياسيون إلى رفع منسوب التأييد الشعبي. إنها ذاكرة مُنتقاة، لا وطنية، تُستخدم لا للبناء، بل للابتزاز العاطفي.
ما نحتاجه ليس نسيان الحرب، بل مواجهتها بشجاعة. لا بالمزايدة، بل بالاعتراف المتبادل. لا بتكرار الخطاب الحزبي، بل بإعادة سرد الذاكرة من زاوية إنسانية، شاملة، عادلة.
نحتاج إلى إعلام يرفع صوت الضحايا، لا يُروّج للمقاتلين. إلى مناهج تعليمية تعلّم أبناءنا كيف سقط الوطن، لا كيف انتصرت الطائفة. نحتاج إلى مشروع دولة... لا مشروع ذاكرة حزبية.
لبنان لا يحتاج إلى "بطولات" جديدة، بل إلى نهاية لهذا الفصل المفتوح منذ خمسين عاماً. فالبطولة الحقيقية اليوم ليست في من حمل السلاح، بل في من يصرّ على أن لا يُرفَع من جديد.
دعوا الشهداء يرتاحون في ذاكرة وطنية تُنصف الجميع. ولا تجعلوا من الماضي سلاحًا لتفخيخ الحاضر. فالدولة التي تحترم نفسها لا تعيش في ظلال الحروب، بل في ضوء العدالة.