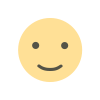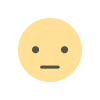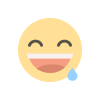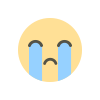إذا كان الدستور اللبناني يلحظ آلية واضحة لمحاسبة من يخلّ بالواجبات الوطنية أو يمسّ السيادة، فلماذا لم يتحرك المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟ وهل باتت النصوص الدستورية معلّقة عندما تطال الشبهة مواقع سياسية نافذة؟
بقلم هئية التحرير خاص مراسل نيوز

لم يعد الانهيار في لبنان حدثًا طارئًا، لكن ما كُشف أخيرًا تجاوز كل ما اعتاده اللبنانيون من فضائح، لأن الخطر هذه المرة لم يأتِ من الخارج فقط، بل خرج من داخل المؤسسات نفسها، وباعتراف علني، وبلا تردّد. أن يُقرّ ممثلون منتخبون بأن قرارًا سياديًا من أخطر القرارات الدستورية، وهو تسمية رئيس حكومة، قد تغيّر بفعل مكالمة هاتفية من جهة مجهولة الصفة والهوية، فهذه ليست زلّة سياسية، بل لحظة سقوط مكتملة الأركان.
هنا، لا تعود القضية اسمًا مستعارًا، ولا شخصية غامضة، ولا حتى دولة بعينها. القضية أعمق وأخطر: انهيار فكرة النيابة، وانكشاف هشاشة القرار الوطني، وتحول البرلمان من سلطة تمثيلية مستقلة إلى مساحة انتظار لإشارات خارجية، حقيقية كانت أم متخيّلة. عندما يصبح الهاتف أقوى من الدستور، والاتصال أرجح من القناعة، نكون أمام دولة فقدت مناعتها السياسية قبل أن تفقد اقتصادها.
في أي نظام ديموقراطي، النائب هو وكيل عن الشعب، لا عن وسيط، ولا عن نفوذ، ولا عن صوت عابر للحدود. الاعتراف بتبديل المواقف تحت ضغط خارجي لا يمكن تبريره بخطاب سياسي، ولا تسويغه بذرائع الواقعية، لأنه ينسف معنى التمثيل من أساسه، ويضرب جوهر العقد بين الناخب ومن انتخبه. هنا يصبح السؤال ملحًّا: من كان يتخذ القرار؟ ومن كان يمثّل الناس؟ ومن كان يحكم فعليًا؟
الأخطر من الواقعة نفسها هو ما كشفته من قابلية عامة للاختراق. فالدول لا تسقط فقط عندما تُخترق، بل عندما تصبح نخبها مستعدة للتجاوب مع أي سلطة متوهَّمة، وعندما تُبنى القرارات المصيرية على إشارات لا تمر عبر المؤسسات، ولا تخضع للمساءلة، ولا تحترم أبسط قواعد الشفافية. هذه القابلية هي العدو الحقيقي للسيادة.
الاحتماء خلف عبارات من نوع «القضية في عهدة القضاء» لا يكفي. القضاء يُحاسب على الجرم، لكن السياسة تُحاسب على الأمانة. الصمت في قضايا السيادة ليس حيادًا، بل مساهمة في تعميم العطب وتأجيل الانفجار. الثقة العامة لا تُرمَّم بالصمت، بل بالمواجهة وتحمل المسؤولية وإعادة الاعتبار لفكرة المحاسبة.
لبنان ليس ساحة رسائل، ولا منصة تجريب نفوذ، ولا شركة تُدار بالمكالمات. هو بلد جريح، نعم، لكنه ليس بلا كرامة. وشعبه، رغم الانهيار، لم يفقد ذاكرته ولا قدرته على التمييز بين من يمثّله ومن يستعمله. العالم يراقب، لأن ما يحدث هنا ليس شأنًا محليًا، بل نموذجًا صارخًا لما يحدث عندما تُفرَّغ الديموقراطية من مضمونها وتتحول المؤسسات إلى واجهات شكلية.
إن أي إصلاح حقيقي يبدأ من مساءلة سياسية وأخلاقية واضحة، ومن إحالة كل من يثبت تورطه في التأثير على القرار السيادي اللبناني نتيجة تواصل أو ضغط خارجي إلى المسار القضائي المختص، وفقًا للدستور والقوانين المرعية. فالدولة التي لا تحمي قرارها، ولا تحاسب من يفرّط به، تصبح كيانًا معلّقًا، قابلًا للانهيار عند أول رنين هاتف.
وإذا لم تُواجَه هذه اللحظة بشجاعة، فلن يكون السؤال في المرحلة المقبلة عن اسم المتصل أو صفته، بل عن بقاء الدولة نفسها. لأن السيادة التي لا تُصان بالفعل، لا تُستعاد بالشعارات.