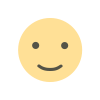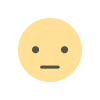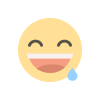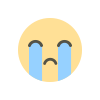ترمب في الواجهة… وميلر في غرفة القرار: كيف تُدار أميركا من خلف الستار؟
بقلم الباحث والكاتب السياسي عبد الحميد عجم

في عالم السياسة، لا تُصنع التحولات الكبرى عبر الخطب وحدها، ولا تُدار الدول العظمى من خلف المؤتمرات الصحفية، بل تُرسم في الغرف المغلقة، حيث تُكتب القرارات بعيدًا عن عدسات الكاميرات، وتُحدد مصائر الشعوب دون ضجيج. في الولاية لدونالد ترمب، بات واضحًا أن البيت الأبيض لا يُدار من شخص واحد، بل من منظومة متكاملة يقف في واجهتها رئيس شعبوي يتقن مخاطبة الغضب الشعبي، وفي عمقها مستشار أيديولوجي يحوّل هذا الغضب إلى سياسات وقوانين، اسمه ستيفن ميلر.
ترمب يعرف كيف يخاطب المخاوف، وكيف يحوّل القلق الاجتماعي والاقتصادي إلى طاقة انتخابية، أما ميلر فيعرف كيف يحوّل هذه الطاقة إلى أدوات حكم، وكيف يترجم الشعارات إلى منظومة قانونية وإدارية تمس حياة الملايين. هنا لا تعود الديمقراطية إطارًا للمشاركة، بل وسيلة لإعادة إنتاج السلطة، وتصبح الانتخابات مدخلًا لإقامة نظام شديد المركزية، تُختصر فيه صناعة القرار داخل دائرة ضيقة شبه مغلقة، تمر عبرها الأوامر التنفيذية، والاستراتيجيات الأمنية، وخطط الضغط الاقتصادي، ومشاريع القوانين، دون رقابة حقيقية أو نقاش مؤسسي واسع
في هذا النموذج، تُدار الدولة بعقلية الحصار الدائم. العالم يُقدَّم للرأي العام كساحة تهديد مستمر، والمهاجر يُصوَّر كخطر، والحليف كشريك مؤقت، والخصم كهدف مشروع، بينما يُختزل القانون في أداة مرنة تُستخدم عندما تخدم المصالح وتُهمَّش عندما تعيقها. من هنا، لم تكن سياسات الهجرة، ولا مشاهد الفصل والترحيل، ولا القيود القانونية، مجرد إجراءات طارئة، بل كانت اختبارًا مبكرًا لنموذج حكم يقوم على الردع والتخويف وإعادة تعريف الانتماء.
وحين انتقل هذا المنطق إلى السياسة الخارجية، ظهر بوضوح في ملفات فنزويلا وغرينلاند وغيرها، حيث عاد خطاب السيطرة والنفوذ بلغة جديدة، تؤكد أن القوة تسبق الشرعية، وأن المصالح تسبق القواعد الدولية. لم يكن ذلك انحرافًا مؤقتًا، بل تعبيرًا عن رؤية ترى العالم مناطق نفوذ قابلة لإعادة التوزيع، وفق ميزان القوة لا وفق القانون.
بالتوازي مع ذلك، جرى العمل على إعادة هندسة الرواية الإعلامية. لم تعد الأزمات تُعرض كقضايا سياسية قابلة للنقاش، بل كمعارك وجود، ومؤامرات، وتهديدات مصيرية، بما يسمح بتعبئة الجمهور وتحييد أي معارضة داخلية. الإعلام هنا لا يؤدي دور الرقابة، بل يتحول في كثير من الأحيان إلى جزء من منظومة التعبئة، تُدار فيه الحقيقة وفق متطلبات اللحظة السياسية.
في العالم العربي، تنعكس هذه العقلية بوضوح في إدارة الملفات الإقليمية. لا مكان لمنطق الشراكة المتوازنة، بل تسود لغة الصفقات، والضغوط، والمقايضات، حيث تُربط القضايا الكبرى، من فلسطين إلى الطاقة إلى العقوبات والتحالفات، بحسابات آنية لا برؤية استراتيجية طويلة المدى. النتيجة هي حالة دائمة من عدم الاستقرار، وتراجع في مكانة القانون الدولي، وتعزيز لسياسة الأمر الواقع.
المفارقة أن هذا النموذج يعمل داخل نظام يُفترض أنه ديمقراطي، لكنه في الواقع يشهد تآكلًا تدريجيًا في دور المؤسسات، وتراجعًا في آليات المحاسبة، وتضييقًا على المساحات النقدية. ومع تركّز السلطة، وضعف الرقابة، وتحويل الخلاف السياسي إلى صراع هوياتي، تصبح الديمقراطية شكلًا بلا مضمون، وتُفرغ من جوهرها التشاركي.
وحتى لو غادر ترمب المشهد السياسي يومًا، فإن البنية التي تشكلت في عهده، بمساهمة مركزية من ميلر، لن تزول بسهولة، لأنها لم تُبنَ على شخص، بل على ثقافة سياسية جديدة تقوم على القومية الصلبة، والخوف، والانعزال، والارتياب من العالم. إنها ثقافة تُعيد تعريف موقع أميركا في النظام الدولي، وتعيد رسم علاقتها بحلفائها وخصومها على حد سواء.
ليست المسألة إذًا في رئيس مثير للجدل أو مستشار متشدد، بل في منظومة حكم تتشكل في الظل، وتعيد صياغة السياسة والسلطة والعلاقات الدولية وفق منطق القوة لا منطق التوازن. ترمب هو الصوت المرتفع، وميلر هو العقل المنظم، لكن الخطر الحقيقي يكمن في المشروع الذي يجمع بينهما، وفي آثاره التي تتجاوز حدود الولايات المتحدة لتطال العالم بأسره. ومن لا يقرأ هذه المعادلة بعمق اليوم، قد يجد نفسه غدًا أمام واقع دولي جديد لم يشارك في صناعته، لكنه مضطر لدفع ثمنه.